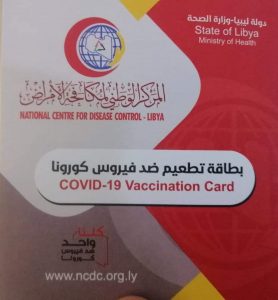تحقيق : زهرة موسى
تتراكم القصص منذ سنوات، ومع كل نداء أمّ، أو صورة لمفقود، يطوى ملف جديد في رفوف الإهمال، ويُضاف رقم إلى قائمة لا تنتهي ، ثم تُطوى الحكايات في صمت، وتُعلّق على جدران التواصل الاجتماعي أو في تقارير حقوقية لا تسأل عنها الحكومات كثيرًا.
ملف الإخفاء القسري في ليبيا لم يعد ظاهرة هامشية، بل صار علامة سوداء في حاضرٍ مشوّه.
عاماً بعد آخر، يتصاعد عدد المختفين، دون أن تُفتح نوافذ الحقيقة، أو يتحرّك القضاء، في ظل غياب الشفافية واستمرار إفلات الجناة من أي مساءلة.
فمنذ العام 2011، ومع تعاقب النزاعات المسلحة، تحوّلت ليبيا إلى ساحة للفوضى الأمنية والانهيار المؤسسي، في هذا المناخ المضطرب، اختلطت المعارك بالاعتقالات، والاختطافات بالتصفية.
وراء هذه القصص، ليس هناك فقط أرقام أو وجوه باهتة، بل بشر حقيقيون: أبٌ خرج ولم يعد، أخٌ أُخذ من منزله في ظلمة الليل، شابة اعتُقلت دون أي تهمة، وفي كل بيت ليبي، حكاية ناقصة تبحث عن نهايتها.

“ظلّ أخي في الحلم والأمل لا يموت“.
تختلف الأسماء والوجوه، لكن الوجع واحد. في سبها، تقول “ت ، ش” “ما زلت أسمع صوته، وكأن الوقت توقف يوم اختفائه”، فمنذ العام 2012، خيّم الغياب على بيتنا، غياب أخي الذي اختفى دون أثر. لم نعرف له قبراً، ولا وصلاً، فقط ظلّ اسمه يتردد في أحاديثنا، وصورته تسكن قلوبنا.
تقول بأسى يزورني في المنام كل فترة، دائماً بنفس الملامح، لكنه مختلف تماما عما كان عليه ، في الحلم يعود إلينا شامخًا، أكثر صحة وأناقة، كأنه خرج من زمن آخر، كأنه عاد بعد رحلة طويلة، كما لو أنه تقلّد مسؤولية عظيمة في الغربة.
حين أتابع أخبار من يُفرَجُ عنهم من السجون أو يتم العثور عليهم ، ووجوههم التي أنهكها الظلم، يراودني نفس الخيال: ربما في أي لحظة سيتصل بنا، صوته على الخط الآخر يقول: “أنا طلعت… راهو أني حي”، لعلّ يوماً يأتي ويعود، كما في الحلم.
رغم أن عقلي يهمس لي بأن الأمل بات معلقًا بخيط واهٍ، وأن من المنطقي بعد هذه السنوات الطويلة ألا يكون حيا ، فلهذا أحيانا كثيرا ما تمنيت أن يكون ميتا على أن يكون خلف القضبان في سجون أصبحت عنوانًا لانتهاك الكرامة و الإنسانية.
بلا أثر.
تضيف ” أ ، م ” رغم مرور أكثر من 8 سنوات لازلت أعتقد بأن ابن أخي حي و سيعود يوما ما ، ابن أخي الذي كان في نهاية العام 2017 قادما من طرابلس متجها إلى سبها و فقدنا الاتصال به عند منطقة الشويرف ، و لا نعلم ما حدث معه ، مرت الأيام و السنوات بحثنا كثيرا ولكن لا أثر له.
حتى اليوم لا جثمان ولا حتى مطالبين بفدية ، فلهذا لا نعي ما حدث له، و لازلت أدعي أن يكون على قيد الحياة و يعود لحضن أمه المكلومة.
تردف ” ع ،ع ” أخي البشوش صاحب الابتسامة الجميلة ، كان بالرغم من أنه مشاغب إلا أنه الأقرب لقلب أمي ، سافر قبل 3 أعوام مع أصدقائه إلى المنطقة الشرقية ، و انقطعت عنّا أخباره ، وواصلوا البحث لأشهر ولم نجد أي معلومة عنه ، و حتى أصدقاؤه قالوا بأنه كان معهم و خرج و لكنه لم يعد، و خرج برفقة أحد الشباب ، الذي بات المتهم الوحيد بقضية اختفاء أخي.
ولكن بالرغم من ذلك لم نصل لشيء ، استمر البحث لأكثر من عام ، ليعلنوا أخيرا أنه قد قتل على يد رفيقه ، وهرب الرفيق ولم نجد ما يؤكد ذلك أو يفنده ، وحتى اليوم والدتي لا تصدق وفاته، فلم تجد قبره و لا جثمانه ، ولم يعترف المتهم بأنه قتله بالفعل.

النساء المغيبات: غياب يُضاعف الصمت.
ليست النساء بمنأى عن هذا العنف، بل إن غيابهنّ يحمل وجعًا مضاعفًا في مجتمع يُحمِّل الضحية اللوم.
النائبة سهام سرقيوة اختُطفت من منزلها ببنغازي في يوليو 2019، ولا يزال مصيرها مجهولًا. تقول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن ما حدث جزء من نمط ممنهج لقمع الرأي.
تقول الصحفية “ع.م”: “حين تختفي امرأة، لا يُرفع الصوت بل يُخفض أكثر،و نُلام على اختفائنا، كأننا مذنبات.”
رهف الكرشودي: طفلة وثّق موتها العنف.
في مشهد مأساوي، تعرّضت رهف ذات الـ15 عامًا لتعذيب موثق على يد أحمد الدباشي، المعروف بـ”العمو”. رغم فتح قضية، لا يزال القاتل طليقًا.
وفي حالة أخرى، اختفت الفتاة رؤية الأجنف. صرخت أمها: “ابنتي مفقودة”، ولم يصغِ أحد. بعد أيام، وُجدت جثتها محروقة، معذبة.

واقع يتفاقم… دون عدالة.
في يونيو 2025، وثّقت منظمة مراقبة الجرائم في ليبيا LCW اعتقال 23 مدنيًا، بينهم أطفال وناشطون، دون إذن قضائي. بعضهم اختفى من بيته، كحالة حسين أغريرة في سرت ، كما تم توثيق إعدام مراد منصور بعد مداهمة منزله ، و كذلك الناشط عبد المنعم المريمي الذي تم اختطافه مع طفليه، ليعيدوهما لاحقا ، و يتوفى هو في ظروف غامضة داخل مقر النائب العام .
تقول ” خ ، م ، ناشطة حقوقية ” تقع المسؤولية على عاتق المؤسسات الحكومية والقانونية فدور هذه الجهات يجب ألا يقتصر على تسجيل الحالات، بل أن يكون العمل جادًا وحاسمًا في كشف مصير المفقودين، ومحاسبة المتسببين في اختفائهم، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للأسر المتضررة.
أنظمة تشرعن الإخفاء.
يقول الناشط الحقوقي ( م ، و ) إنّ “الإخفاء القسري في ليبيا يُغذيه مزيج خطير من الانقسام السياسي والمؤسساتي، وغياب سلطة موحدة تحمي الحقوق وتفرض القانون، إلى جانب تفشي الإفلات من العقاب، وسيطرة جماعات مسلحة على مراكز الاحتجاز تعمل خارج إطار الدولة“.
الإخفاء أدة للترهيب.
يضيف: “في كثير من الحالات، يُستخدم الإخفاء كأداة لترهيب المعارضين السياسيين والنشطاء، وسط عجز كامل للأجهزة القضائية عن التدخل أو المحاسبة“.
ويشير إلى أن “بعض المناطق الليبية تشهد ممارسات ممنهجة للإخفاء القسري، خاصة تلك التي تخضع لسلطات الأمر الواقع، حيث يتم احتجاز المواطنين دون أوامر قضائية ويُمنعون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم”، مضيفًا أن “مناطق أخرى قد تُسجّل حالات فردية، لكن البيئة العامة من الفوضى والانفلات الأمني تُكرّس استمرار هذه الممارسات دون رادع“.
وفيما يخص الأثر السياسي، يوضح: “الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب زاد من تعقيد الملف، إذ لا توجد آلية تنسيق وطنية أو قاعدة بيانات موحدة للمختفين قسرًا، وكل طرف يُلقي باللوم على الآخر، ما ضيّع فرص الوصول إلى الحقيقة“.
وعن مدى وجود إرادة سياسية لحل الملف، يصرح : “حتى اللحظة، لا يمكن الحديث عن إرادة سياسية جادة لمعالجة هذا الملف، بل يُستخدم أحيانًا كورقة للمقايضة السياسية، دون خطوات فعلية لإنشاء آلية وطنية مستقلة للتحقيق والمساءلة“.
وحول تعامل القضاء الليبي، يضيف: “النيابة العامة وأجهزة القضاء لم تُبدِ حتى الآن فعالية في التحقيق بملفات الإخفاء القسري، بسبب ضعف الاستقلالية، وخضوع بعضها لنفوذ جماعات مسلحة تمنع الوصول إلى المتورطين أو تطمس الأدلة“.
وفي معرض حديثه عن العوائق، يقول: “الناشطون الحقوقيون يواجهون تهديدات مباشرة، وبيئة عدائية للعمل الحقوقي، فضلًا عن صعوبة الوصول للمعلومات، ورفض الجهات الأمنية التعاون، والخوف الشديد لدى العائلات من الإدلاء بشهاداتهم“.
كما يؤكد أن “الفئات المستهدفة لا تقتصر على النشطاء فقط، بل تشمل الصحفيين، والمهاجرين، والمدنيين من مناطق معينة أو منتمين لقبائل معارضة، وحتى عناصر أمنية سابقة غير موالية للسلطات القائمة“.
واختتم قائلًا:”نحن بحاجة إلى مساءلة حقيقية، وآلية وطنية شفافة، وضغوط دولية فعّالة تضع حدًا لهذا الانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية، لأن الصمت يُغذي استمرار الجريمة“.
وفي ذات السياق، توضح القانونية (م. هـ) أن القانون الليبي لا يتضمّن تعريفًا صريحًا ومباشرًا لهذه الجريمة، لكنه أشار إليها ضمن المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 2013، معتبرًا أن كل من خطف إنسانًا أو حبسه أو حرمه من حريته بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع، فإنه يرتكب فعلاً يُعاقب عليه القانون.
أما على الصعيد الدولي، فتستند (م. هـ) إلى المادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، والتي تضع تعريفًا أكثر دقة وشمولية، حيث تُعرف الجريمة بأنها: القبض على شخص أو احتجازه أو اختطافه من قبل موظفين تابعين للدولة أو من قبل مجموعات تعمل بإذن منها أو دعمها، ثم إنكار مصيره أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ليبيا، رغم توقيعها على عدد من المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1970، واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1989، لا تزال تتعثر في تفعيل هذه الالتزامات فعليًا داخل تشريعاتها ومؤسساتها.
تُشير (م. هـ) إلى أن القانون الليبي وضع عقوبات متفاوتة لهذه الجريمة في القانون رقم 10 لسنة 2013، تبدأ بالسجن لكل من مارس فعل الإخفاء، وتشتد العقوبة في حال كان الفاعل موظفًا عامًا، أو ارتكب فعلته ضد أحد أقاربه أو زوجته، أو بدافع الحصول على كسب مالي مقابل الإفراج. في بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، خاصة إذا أفضت الجريمة إلى الوفاة أو استمرت لفترة طويلة.
ويُعزّز هذا التوجه أيضًا في قانون العقوبات الليبي، خاصة في المواد 424 و435، التي تُشدد العقوبات في حال ارتبط الإخفاء بالتعذيب أو التهديد بالقتل.
ورغم هذا الإطار القانوني، فإن الواقع يشهد قصورًا واضحًا في تطبيق العدالة، لا سيما حين تكون الجهة المرتكبة للجريمة هي ذاتها المسؤولة عن إنفاذ القانون.
وعن موقع هذه الجريمة في سياق المصالحة الوطنية، تشير (م. هـ) إلى أن قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013، وصف الإخفاء القسري بأنه من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب الكشف والتوثيق، كشرط أساسي لبناء سلام مجتمعي حقيقي.
وعن كيف يمكن ضمان عدم الإفلات من العقاب في بيئة يغيب عنها الاستقرار وتكثر فيها الولاءات؟ تجيب القانونية بثقة: “لا سبيل إلا بالتوثيق المنهجي، والدفع نحو المحاسبة القانونية، ودعم أجهزة القضاء، والتعاون مع المجتمع الدولي لملاحقة الجناة ومساءلتهم أمام القانون.”
تؤمن (م. هـ) كذلك بأن جبر الضرر لعائلات الضحايا لا يتوقف عند حدود التعويض المالي، بل يتعداه إلى تخليد ذكرى المفقودين، وكشف الحقيقة، وإنشاء كيانات مدنية تتولى هذا الملف الحساس، تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، وتتحرك بمهنية واستقلالية.

وفيما يخص الجهات المرتكبة لهذه الجرائم، تلفت إلى أن المشهد معقد، حيث تساهم فيه أطراف متعددة: جهات حكومية تنفذ اعتقالات دون إذن قضائي، وتشكيلات مسلحة تعمل تحت مظلة الدولة، وأخرى خارج نطاق الشرعية لكنها تتقاضى أموالاً من المال العام.
أما حين تُطرح الأسئلة عن مستقبل العدالة في أية تسوية سياسية قادمة، فإن (م. هـ) لا تتردد في القول إن الطريق يبدأ بإقرار قانون خاص بجرائم الإخفاء القسري، يضمن آليات واضحة للمحاسبة والتعويض، ويضع حداً لتكرار هذه الانتهاكات، كما يضمن محاكمات عادلة لمن تورطوا فيها، أياً كانت صفتهم أو مناصبهم.
رؤيتها بالإيمان العميق بدور المجتمع المدني، ليس كفاعل مساعد، بل كقوة تغيير قانونية وإنسانية. فبحسب قولها :“توثيق الحالات، تقديم الدعم القانوني للأسر، حملات التوعية، التعاون مع المنظمات الدولية، وحتى رفع القضايا أمام الهيئات الدولية، كلها أدوات علينا أن نستخدمها، لأن الصمت لم يكن يومًا حلاً، ولأن غياب الحقيقة يُعمّق الجرح أكثر.”
ختاما“
رغم تكرار قصص الاختفاء، تظل الحقيقة مطمورة تحت ركام الغموض والسكوت. القانون يضع إطارًا يحمي حقوق الإنسان، ويندد بالإخفاء القسري كجريمة لا تسقط بالتقادم. لكنه يبقى حبرًا على ورق حين يغيب التنفيذ، ويظل الأمل معلقًا على وعود بتحقيق العدالة والمحاسبة.