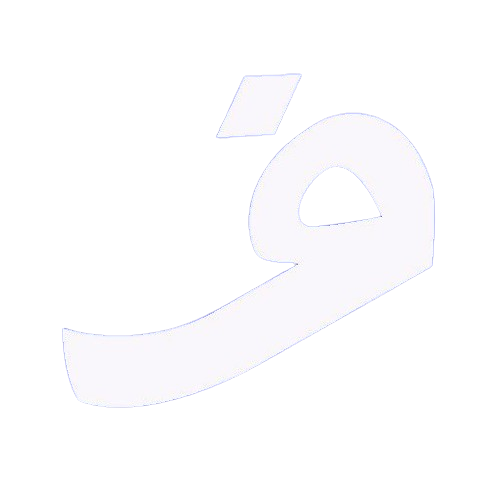- محمد عبدالحميد المالكي
يقترح جاك دريدا مفهوم التحويل(Transformation) بدلا من مفهوم الترجمة. ذلك أن الترجمة ليست فقط من لغة أجنبية إلى اللغة الأم، بل أيضا داخل اللغة نفسها. أو كما يؤكد هيدغر: “إنه إن كانت عملية الترجمة تَلاقٍ ما بين لغتين، و تجعلهما تدخلان في حوار بينهما، فإن ذلك لا يشكل العنصر الجوهري للترجمة.. لأن الكلام نفسه، إذا نُطق به، و كتب داخل اللغة الأم، يكون في حاجة إلى تأويل. وبالتالى، فإن هناك بالضرورة ترجمة، و ذلك داخل اللغة الأم ذاتها”. و لعل هذا ما يبرر وجود قواميس لا تنقل لغة إلى أخرى، و إنما تترجم اللغة ذاتها. ما يشكل جوهر الترجمة. إذ ليس كونها حركة بين اللغات، وانم٦ا كونها تأويلا، “فالتأويل والترجمة هما في جوهرهما الشيء نفسه”.( ) عندما اشتغل جاك دريدا على مسألة “الترجمة خلص إلى أن “لا وجود لمعنى أصلي للغات، بعد ما تعرضت الألسن إلى البلبلة، بعد كارثة انهيار برج بابل.( ) وهنا يلتقط إحدى النتائج العلمية المتأخرة لرائد اللسانيات البنيوية “رومان جاكبسون(عن الترجمة1957)، وما دعاه بالترجمة “داخل اللغة Inter- Language” أو إعادة الصياغة “Rewording”؛ و التي تهتم بعلاقات التحويل القائمة بين أسماء الجنس والجمل العادية، كما يميز بين ثلاث أشكال للترجمة: 1) الترجمة داخل اللغة تؤول العلامات اللسانية بواسطة علامات من نفس اللغة. 2) هناك بعد ذلك، التسمية الجميلة، التي أطلقها جاكبسون على الترجمة الحقيقية، وهى: الترجمة بين اللغات (أو داخل اللغة Inter- Language)، والتي تؤول العلامات اللسانية بواسطة لغة أخرى، وهو ما يؤدي الى نفس مقتضيات الترجمة داخل اللغة. 3) أخيرا: الترجمة على مستوى التبادل الدلالي(Inter-Semiotic) أو التحويل الذي يؤول مثلا العلامات اللسانية بواسطة علامات غير لسانية. (دريدا، 254 ) تسعى بعض الدراسات والأبحاث الحديثة لتصنيف وتمييز النصوص الشفوية عن المكتوبة، فيما يخص الاختلاف بين تقنيات وآليات الإلقاء والكتابة. لأهميتها بشأن التساؤل: كيف وصلت إلينا تلك النصوص الكلاسيكية في شكلها النهائي الحالي؟ مثل: ألف ليلة وليلة، الزير سالم، السيرة الهلالية..الخ. وكيف كانت آليات النسخ والنقل، قبل اختراع الطباعة؟ ومسائل عديدة أخرى، ولكن يعنينا منها هنا، كيف كانت تقنيات “الإملاء والإلقاء” للشيوخ المعلمين على المريدين والأتباع؛ والناسخ منهم تحديداً؟ أو كيف أن بعضهم كان على درجة عالية جداً من التركيز والإتقان، في المواكبة السريعة في الكتابة، ذلك لأن الكلام الشفوي أسرع من حركة اليد في الكتابة. وتتمثل مهارة الناسخ؛ في التعديل والتغيير، بل وحذف الألفاظ التي تتكرر في الجملة الواحدة. إذ أن تكرارها في الشفهي قد يكون مقبولاً؛ نتيجة لسرعة الاستماع و بطء حركة اليد، وضعف تركيز حركة العين من جهة اخرى.( ) ونحن نتكلم على الواقعة اللسانية على المحور التعاقبي(السيكروني الزمني)، أو تغيير النصوص عبر الزمن، كما هو الحال في النصوص التراثية القديمة، والتي تحتاج إلى مقدمات للتفسير وشرح بالهوامش أيضا(التحقيق) ألا يمكن اعتبارها أنها ترجمة أيضا؟.وكما يقول هيدغر:”إن الكلام نفسه إذا نطق به و كتب داخل اللغة الأم يكون في حاجة إلى تأويل، وبالتالي، فإن هناك بالضرورة ترجمة، وهذا داخل اللغة الأم ذاتها”.(ترجمة 33 ) بل قد نذهب أبعد من ذلك مع “امبرتو ايكو” أيضا في محاضرة له عن اللغة المثالية/ النموذجية. إذ ليس هناك لغة واحدة، بل هناك لغات متعددة داخل اللسان الواحد. لأن اللغات الدارجة(اللهجات) لا تختلف بين المدن والقرى فقط، بل تختلف أيضا داخل المدن بين الأحياء الفقيرة وتلك الغنية. وكذلك بين كل المجموعات اللسانية المختلفة لأصحاب المهن الواحدة وبين الشباب والكهول. وكل هذا تحتاج إلى عمليات شرح وتعبيرات اذ٦ا لم يتفاهم كل هؤلاء الفرقاء. كأن يستفسر أحدهما عن معنى مفردة من المفردات أو شرح معاني الكلمات.(هل هناك معنى آخر لمفهوم الترجمة؟).