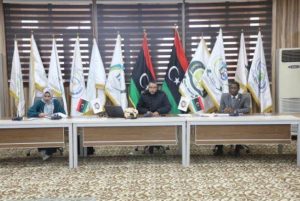نبيل قديش
ربّما حان الوقتُ لأحكي لكم عن أمل. أمل شابّة يتيمة سكَنت مدينة عين دراهم بأقصى الشمال التونسيّ قبل أن تموت. في صباها تمنّت أن يكون لها دمية كبيرة من القطن رأتها بين أحضان ابنت الجيران المدلّلة. سألت أمّها دمية تشبهها فطلبت منها أن تسأل الله. انتظرت كثيرا ولم يستجب الله. في طريقها إليه تسلّقت عموداً شاهقاً للضغط العالي والنّاس شهودٌ يحبسون أنفاسهم. تلقّت صعقة كهربائيّة شديدة أفقدتها الإحساس بذراعيها. كان على الأطبّاء المسعفين بترها تقريباً عند مستوى الكتفين، في حين كان يمكن إنقاذهما في مصحّة خاصّة.
لم تجد أمّها يومذاك سيّارة تسعف وحيدتها ناهيك عن المال الكافي لإيوائها في إحدى مصحّات العاصمة. كان البتر دائما وأبداً الحلّ الأجدى والأسلم فوق تلك الأرض النائية البعيدة عن المركز. كبرت أمل في “عين دراهم” من دون أمل أيضاً في ذراعين صناعيّتيْن بعد أن فقدت الأمل في الدمية. تعقّدت حياتها، أصبحت لا تُطاق. هناك أيضاً، كان الاستمرار على قيد الحياة مضنٍ ومكلفٍ للأصحّاء ناهيك عن الذين سلبتهم الطبيعة بعض أعضائهم ولم يكن لديهم ألعاباً.
لكن ذلك لم يكن كلّ شيء!
قرّرت أمل أن تنتقم من نفسها والآخرين بأن تصبح عاهرة. نعم لقد اختارت أن تعاند نفسها وأمّها والنّاس والورع الزائف لشيوخ الحيّ الذين وعدوها كلّهم بدمية وأخلفوا الوعد. عنادها لم يقف عند ذلك الحدّ، ذلك أنّها تعقّبت حلمها في أن تصبح عازفة على آلة “الجيتار”. ماذا كان بإمكانها أن تصبح غير ذلك؟ لقد كانت التوليفة الوحيدة للخلاص أو هكذا ظنّت المسكينة؛ معاقة ومومساً وعازفة… غير أنّه من الصعب تقبّلُ ذلك إذا ما كان الواحدُ فقيراً ويعيش فوق أرض ثالثة. لو كانت فاتنة وغنيّة لاستقام الأمر، لكنّ أمل كانت فتاة عاديّةً جدّاً ومعدَمة.
تفرّغت لملاحقة ما ظنّتها أحلاماً تحقّقها بنفسها. درست بجدّ لوحدها. عزفت وغنّت في الشوارع. وقعت في حبّ كلّ رجل يقترب منها. لكنّ خيبة أملها زيادة إلى شعورها بالذلّ واحتقار الآخرين لها كانا فظيعيْن. توقّفت فجأة في شطر الطريق وقرّرت وضع حدّ لحياتها. ذات مساء صيفيّ حزين، عندما اختفى قرص الشمس في جوف المتوسّط، قفزت أمل إلى البحر من صخرة تستخدم تحديداً للانتحار على شاطئ صخريّ في مدينة طبرقة يعرفها الناس باسم “البُونْتَه”. طبعاً لم تكن ملزمة لربط نفسها بحجر أو شدّ ذراعيها بحبل إلى الخلف مثلما يفعل جلّ المنتحرين. غرقت مثل كرة رصاص. بعينين مفتوحتيْن رأت الماء كلّ مرّة أكثر سواداً. ميّزت الفقاعات التي كانت تخرج من فمها وأنفها وأسرّت لنفسها برضى تامّ:
“اليوم ينتهي كلّ شيء”.
سمعت صوتاً مضادّاً يعاندُ:
“لا يا أمل، لم ينتهِ كلّ شيء!”.
لم يكن صوتها، لكنّه صدح من مكان قريب جدّاً، من جوفها ربّما أو من ذاكرتها. فجأة وبحركة لا إراديّة من قدميها طفت على السطح. دفعها الموج الخفيف لترى الشاطئ وصخور الساحل المتاخم وصواري قوارب النزهة والصيد. عادت وغطست مرّة أخرى. لم تغلق عينيها وإنّما حرّكت رأسها بهدوء شخص مخدّر. بحثت بعينيها عن شيء ما، أيًّا كان، شيء جميل يُبقي عليها في اللحظات الحاسمة. لكنّ السواد منع أيّ جسم من الهبوط معها إلى الأعماق ولم ترَ شيئاً.
مرّت حياتها أمام عينيها مثل فيلم قصير مقاطعه بالأسود والأبيض. حُبُّ أمّها المعدَمة، كبرياؤها وبكاؤها عندما تتعانقان في اللّيل صامتتيْن، رعشات الحمّى التي ألمّت بها في اللّيالي الطويلة، المناسبات التي أغرقت فيها فراشها بولاً، المستشفيات التي زارتها طلباً للشفاء ولم تبرأ، نظرات الشفقة التي انهالت عليها من كلّ حدب وصوبٍ، حديقة الحيوان بالألوان التي لم تزرها قطُّ، الأصدقاء الحقيقيّون الذين تقاسموا معها القليل الذي لديهم، الموسيقى التي أفرحتها ولم تطلها، سجائر “الزطلة”، قوارير البيرة، الجمال المكشوف في أماكن غير محتملة بالأسود والأبيض. اللئام الذين كذبوا عليها، أغروها بمعسول الكلام ثم ضاجعوها في بنايات مهجورة وتركوها هناك. كلّ ذلك يُعاش مرّة واحدة. قرّرت بقوّة فجائية أنّها لن تسمح لنفسها بالموت. الصوت الغريب داخلها عاد ليهمس مرّة:
“الآن تبدئين مجدّداً! تعودين حالاًّ إلى اليابسة!”.
كان الصعود إلى السطح يبدو غير منتهٍ، فأن تظلّ طافية شيء لا يُحتمل. لكنّها فعلت. ذلك المساء تعلّمت السباحة من دون ذراعين مثل فقمة.
عادت لتتعلّم مهارات جديدة. رسمت بفمها وأصابع قدميها. رقصت بجذعها من غير أن تحرّك ذراعيها. نظمت شعراً وكتبت رسائل غرام لمشاهير لم تلتقيهم. أذهلت النّاس بالعزف على آلة “الجيتار” بأصابع قدميها وبرعت في ذلك. جمعت القليل من المال حين كانوا يسمحون لها بالعزف على هامش مهرجان “الجاز” على الرصيف هناك خلال تلك الأمسيات التي تمتلئ فيها طبرقة بمشاهير موسيقى “الجاز” القادمين من كلّ العالم.
ادّخرت المال الذي جمعته، قرّرت لاحقاً الهجرة إلى البلد الذي جاءت منه الدمية الجميلة لبنت الجيران. كلّفها ذلك الكثير لكنّها غادرت أخيراً مدينة طبرقة. الحياة في أوروبا بالطبع لم تكن أكثر مرونة. فخلال بعض الوقت، سنوات ربّما، أقامت في نُزل رخيصة في أحياء يعيش فيها مهاجرون مغاربة أو أتراك أو أفارقة، أمضت بعض المواسم السعيدة في بيوت عشّاق، حيث كان ينتهي بها الأمر لتركهم أو العكس. وبعد كلّ يوم عمل، بعد الكؤوس في حانات للشواذّ أو في الحفلات المتواصلة في نوادي السينما، تنعزل أمل في غرفتها، تقضي وقتها في الرسم أو الكتابة.
عاشت وحيدة خلال فترات طويلة من حياتها. كان بعضهم يدعوها بالمرأة الآليّة. يسألها الأصدقاء المقرّبون طبعاً كيف تنظّف مؤخّرتها بعد أن تتغوّط، وكيف تدفع لعاملة المتجر، وكيف تعيد المال إلى حافظة نقودها، وكيف تضع أحمر الشفاه وكيف تسرّح شعرها وكيف تطهو وكيف تلبس جواربها وكيف وكيف وكيف… “كيف بالله عليكم” كانت تجيب على أسئلتهم بسؤال…
التقيتها الصيف الماضي في مدينة طبرقة. أمل ماتت، ليس في ألمانيا، بل غرقاً حين رمت بنفسها إلى أعماق البحر ذلك اليوم من أعلى “البونته”. رأيت الدموع تسحّ من عينها بعد أن تسلّمت منّي الدمية القطنيّة التي اشتريتها لها خصّيصاً. احتضنتني وقبّلتني مثل طفلة غرّة لكنّها قالت إنّ الدمية أتت متأخّرة جدّاً وبعد أن أنتهي كلّ شيء بالنسبة إليها. كانت على ما يبدو قد حزمت أمرها. تركتني ومضت لكنّني صحت فيها أستوقفها، ولم أعرف يومذاك من أين امتلكت كلّ تلك الشجاعة واليقين لأقول لها:
” لا يا أمل! لم ينته كلّ شيء!”