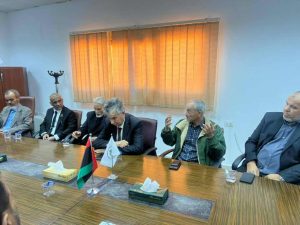بقلم :: محمد أحمد الانصاري
يغلب في جل كتاباتنا وتعبيراتنا وآرائنا التشدد والتعصب ، إما مؤيدة مصطفةً مع أقصى اليمين ، أو مناوئة مصطفة مع أقصى اليسار، مستهدفة المشاعر لا العقل ، وغالباً ما ننكر كل ما يمسنا ونصفه بالتعدي ، ونبرر نفس الفعل عندما يصيب الخصوم ، ونادراً لا نعيد التفكير في “أي منهج أو عقيدة أو قضية ” ، إلا حينما نتعرض لصفعة مؤلمة منها ، وحينها وبدلاً من دراستها وتحليلها وتحت تأثير الصدمة ، نلعن ونشتم منقلبين على أعقابنا،ولا فرق في ذلك بين المراهق الفكري الممتعض ، ولا المرتدي عباءة المثقف . لأسباب كثيرة يعود جزء منها إلى طريقة اعتناقنا إلى هذه الأفكار وإيماننا بها .
ولنكون أكثر قرباً من مرمى الموضوع لابد من استعراض بعض النماذج الواقعية الكثيرة من حولنا.
فعلى سبيل المثال نجد البعض ، ممن ارتدوا عباءة المثقف ، أو الناشط يختزل تراجع مجتمعه في نصه الديني الذى اعتنقه تلقينا لا فهماً و لا دراسة ، ولكى ينفض غبار العصر الحجري من على مجتمعه المتأخر، و يواكب التطور ، لابد أن يقذف موروثه الديني كلياً ، من باب التجديد أو التحديث دون أن يحدد الكيفية أو يؤسس بعد نقده اللاذع ، واثباً للضفة المعارضة ، مستنداً بتجارب أو قفشات يتمتم بها آناء الليل وأطراف النهار ، قرأها من كتاب أكاد أجزم بأنه لم يدرك الطبيعة السياسية والاجتماعية والتاريخية المحيطة بالكاتب آنذاك ، مفرغة المحتوى لا تصمد أمام أول مواجهه منطقية ، إنما تبعية ثقافية ومواكبة لهذه الموضة الجديدة . فالتجديد على أية حال ، هو نتاج التطور الحضاري ، ولا يكون سبباً في تطور المجتمع فليس ثمة فوارق بين المسيحي وحتى الملحد في منطقتنا والمسلم . لتكون النهاية مزبداً من التقوقع ودعاء الحق الكلي . . مجموعات تائهة خشبية يصعب التفريق بينها ، أولى تائهة تعتنق كل ما يروج لها بدعوة الانفتاح ، تنعت خصومها بالمتزمتين المتطرفين ، والثانية جامدة ترى كل ما يخالفها بدعة تنعت خصومها بالمنحلين . وهذا لا يعني نقد ميولهم و خياراتهم، فالخيار يجب احترامه لكن حينما يتحول إلى ما يشبه التبشير اﻹقصائي لﻵخر ، فإنه لا بد من مواجهته لتشريحه ومراجعته خاصة حينما يصدر من النخب .
أو نجد آخر يعد نفسه منبراً للحق متسلحاً بشعارات الوطنية والانتماء، ، يردد دعواته المستمرة بالخير والشفاء والغفران لجريح ما ، أصيب في معاركنا العديدة المجنونة لكونه يميل نحو ميوله ، في حين يلوذ بصمت من في القبور ، عن عشرات آلاف من الجرحى ، في صفوف أبناء وطنه الخصوم ، وأقصى ما يمكن أن يمن به ضميره المتهالك من تعاطف، تلك جمل القميئة ، اللعينة المملولة الباهتة، إحداها ” ما في حد قاللهم اطلعوا امعاه ” ، أو يقف مدعيا الوطنية والإنصاف عبر منابره المتعددة ، التي وفرتها له الفوضى، ليعلن عدم أهلية خصومه ، بأبشع الأوصاف نيلاً وتشهيراً في مجتمعه ،المتربص الذى يدعي النقاء والصفاء العرقي ، ثم حين تهطل أمطار التصالح لا يجد المنتشي حرجاً في انتقاد ذاته ليزين خصمه من جديد ، ليست المعضلة في هذا الأمر فذلك يعد طبيعياً في المجتمعات التى تشهد هزات اجتماعية أو فلتان أمني، ولكن تكراره مع ذات الخصم يدل على تلوث أفكار من يصدر منه وانحطاطها و سوقيتها مهما بلغ ، ولا غرابة في ذلك إنما الغريب الذى يصل إلى حد الألغاز استماتة المتلقي في الاستماع لأمثال هؤلاء .
أو أخرى مكبلة بعرف مجتمعها البائد السائد المقدس والذي ساهمت مساهمة فعالة بتكوينه ولازالت الآلة المواصلة في استمراريته وتحديثه إلى الآن ضد أبناء جنسها . لا تكف أينما وجدت الفرصة المناداة بحقوق المرأة وفكها من قيد الرجل الظالم حسب وصفها ، ووصفه بالمتسلط الجائر الجبار، وقد تكون نداءاتها صائبة وواقعة ولكن “الحقوقية ” وبدون ضغط من فرعون زمانه تقيم ما يشبه المأتم حينما ترزق أو يزرق ابنها “بطفلة” بينما تقيم حفلاً صاخباً حينما تزرق بآخر (ذكرا) .لم يحاول ذلك الصف تحليل عمق مشكلة المرأة مع نفسيتها التي مازالت تعزز ما تطلقه عليه المرأة قيداً بينما لم تجد صعوبة في القفز إلى الضفة الأخرى المعارضة ، فهي الأسهل والمبرر للفشل والأكثر ضجة والأقل تكلفة .
فمتى نشاهد تلك التعابير والآراء المستهدفة للعقل؟ والتي تشعل في أفئدتنا فتيل التساؤلات لفترات طويلة ،ويجبرك مضمونها على أن تنحني لها احتراماً ، رغم اختلافك كلياً معها ـ بدلاً من تلك التعابير العاطفية النارية المخونة الجاحدة المليئة بالنكران , والتي تزيد المتقوقع حول ذاته تصلباً واستماته. وكما قيل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجل ولو كانوا ذوي رحم .