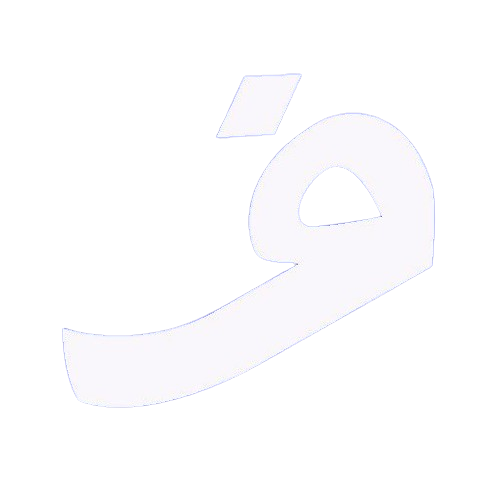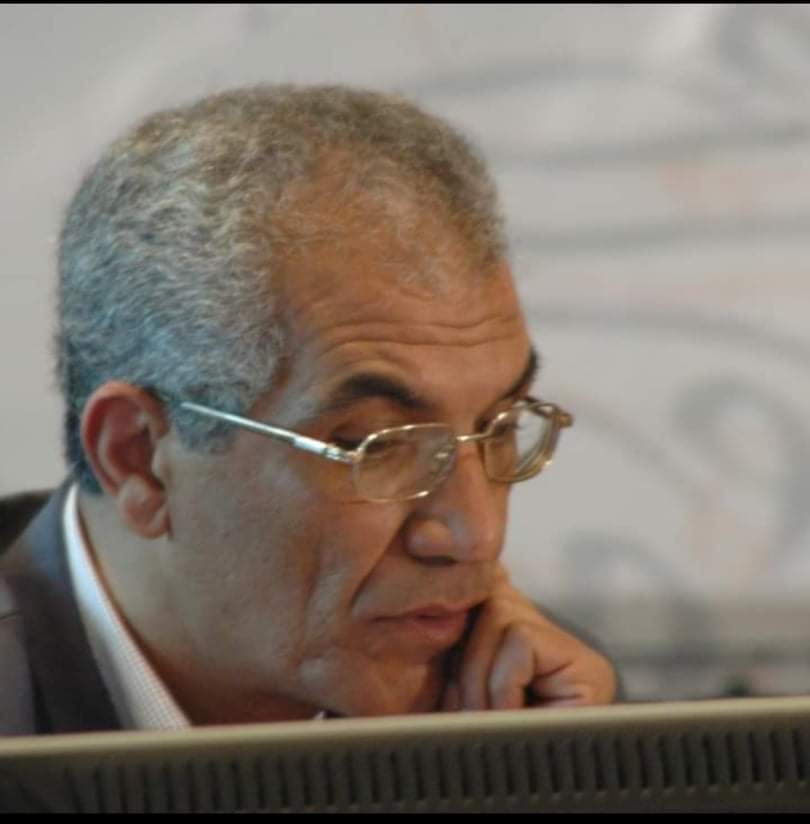محمد عبد الحميد المالكي
مختبر بنغازي للسيميائيات وتحليل الخطاب
“ان اهمية تحليلات (ج. كانغليم) تبين أن تاريخ مفهوم ما، لا ينحصر فى ميله التدريجي نحو الدقة، اوسعيه المتزايد نحو المعقولية وارتقائه نحو التجريد، انما هو تاريخ تنوع مجالات تكونه وصلاحيته، تاريخ قواعد استعمالاته المتعاقبة، وميادينه النظرية المتعددة التى تم فيها ارساؤه واكتمل.. ان الخطر الوحيد الذى يتهدد التأويل هو ان نؤمن بوجود علامات تتمتع بوجود اصلى، اولى، حقيقى..” (ميشيل فوكو)
“بكلمة واحدة مختزلة وجارجة: ان الترجمة صناعة اوتقنية متعددة التخصصات (Multidisciplinary)، وليس كما هو الكلام المرسل الانشائي، بان الترجمة فن اوحتى علم، فيما يلي ستكون مسوغاتنا (او المبررات Justification) الاجرائية العلمية لهذا الاِخْبار..”
باديء ذي بدء، يجب ان يكون الامر واضحا وجليا من ان المعاجم )اوالكلمة ومعناها( ليست سوى تأويل اوترجمة، كما ان المعنى في المعاجم هى عملية مؤقتة، بل ومتعسفة ايضا، ولكنها ضرورة اجرائية وبيداغوجية. الترجمة هى عملية تحويل لـ المعنى، اوهى التأويل، شرح وتفسير، باعتبار ان المادة المعجمية (اللكسيم lexeme) ليست مرادف لـ الكلمة، لان “الكلمة” تختلف قليلا عن معنى “الوحدة المعجمية”، كما ان المعاجم ليست كلمة مقابل معناها، بل اقتراح لتعدد المعنى حسب السياق، الازاحة والبنية الصوتية ايضا.
المعاجم وترجمة المصطلحات والمفاهيم
اذ يشكو المشتغلون بالنقد والفكر من الفوضى والتسيب في الاستخدام العشوائي لترجمة المصطلحات والمفاهيم، أوما يعرف بـ”هجرة المصطلح”، فضلاً عن أسباب عديدة آخرى لسنا في صددها هنا، مما يجعل القارئ عاجزاً عن إدراك الفروقات والاختلافات بين هذه النظرية أوتلك، اوبين هذا المفهوم وذاك. كما لا يدرك كيف أن المصطلح الواحد قد ينتمي إلى مدارس متعددة ، مما يجعل القارئ في حيرة وارتباك، إلى حدود التنفير من العلم، اوأخذ الأمر على أنه مدعاة للسخرية والتندر، وهو لا يعدو ان يكون مجرد تلاعب عبثى لا طائل من ورائه. واذا كان هذا الامر صحيحا من الناحية الوصفية الاستقرائية والانطباعية، فانه وصف يفتقر للبحث في آليات الظاهرة، بسبب الهوس بالبحث عن اصل نقي وشفاف لمعنى مصطلح (مفهوم) ما داخل القواميس والمعاجم، وبالتالي فهو وهم وعبث لا طائل منه، وعلى النحو الذي اثبتته النتائج الابستمولوجية الباهرة لـ”ج. كانغليم” ، ان تاريخ المفاهيم والتطور المعرفي والنظري، لا يعني ان المفاهيم ستكون محددة بدقة شديدة والمعاني ستكون واضحة ويقينية، بل العكس صحيح ستكون متعددة الحقول والسياقات، اى حسب سياق واستعمالات كل نص ايضا. فمن منا لا يتذكر بداياتنا في دراسة علوم اللسانيات والسيميائيات، حيث كنا نقضي الساعات من اجل مطاردة مصطلح او مفهوم ما. اذا كنا لا نلوم الطلاب وشباب الباحثين، بل ربما نتعاطف معهم، بل كل اللوم يقع على مسؤولية الاساتذة، الذين يعانون من هشاشة تأطيرهم المنهجي وضعف تكوينهم الابستمولوجي، الاهم مسؤولية المؤسسات البحثية والاكاديمية العربية، وما مؤشرات التقييم الدولي للجامعات (شنغهاي، اكسفورد)، الا دليل على بؤس ما نحن فيه من تدني المستوى العلمي والاكاديمي.
هنا نود التشديد على ان مسألة الفوضى في استعمالات المصطلحات والمفاهيم تخص كفاءة المترجم (اوالاهلية Competence)، اوالمسؤولية المعرفية، المثابرة والاخلاص الاخلاقي، لانها من شروط الاجتهاد التي تحدد درجة الانجاز في اى عمل، وليس في الحقول العلمية والفكرية فقط. باختصار: ان قيمة اى عمل تتحدد بمقدار الجهد المبذول في انجاز هذا العمل. كما ان هناك عديد من الادباء، رغم انهم ليسوا مترجمين محترفين، فقد ترجموا نصوصا نابضة بالحيوية والنضارة، مثال ترجمة ممدوح عدوان لـ”الطريق الى غريكو” لكزانتزاكس. اما اذا توفرت شروط الاهلية، الاجتهاد في الترجمة والاشتقاق وكافة تقنيات الترجمة والتعريب، فان الامر لا يكون فوضى وعشوائية، بل هو مبدأ تعدد التأويل لصالح الانفتاح الدلالي للمصطلح والمفهوم. فبدلا من البحث عن اوهام مطالبة الباحثين بالاتفاق وتوحيد الترجمة، اوالبحث عن المعنى الاكثر دقة اوالتعريف الجامع المانع..الخ، يمكنك اعتبار كل الاختلاف صحيحة ودقيقة ايضا، طبقا لمبدأ المقارنة، تعدد التأويل واستراتيجية الاختلاف، بالمعنى التجريدي بانشاء علاقات بين تلك الاختلافات، لتصنع مفهومك الخاص، حسب سياق شغلك ومرجعيتك الابستمولوجية ومنهجيتك في انشاء علاقات بين مراجع ومصادر بحثك. مع الاخذ بعين الاعتبار شيوع بعض المصطلحات، يمكنك عمل هامش للتوضيح اوحتى اقتراح ترجمتك الخاصة.. اذن لا داعي للقلق، اذ من حق الباحث المجتهد اقتراح ما شاء، فقط عليه تقديم مسوغات اي اقتراح او فرضية. كما لا تضيع مجهودك فيما لا طائل منه ولا تلهث وراء الاوهام بل ان القراءة ليست كم عدد الكتب والبحوث، اذ ان الامر الحاسم والاكثر اهمية هو كم عدد الساعات التي انفقتها في الشغل؟ مهما كان طبيعة هذا الشغل البحثي، حتى لو كانت البحث في المصطلحات والمفاهيم، اوالمقارنة بين الترجمات المختلفة للباحثين