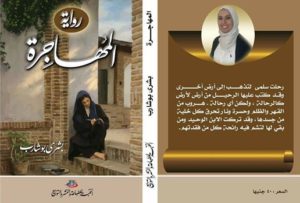بقلم :: عبد الرحمن جماعة
دقيقة واحدة.. هذا هو كل الزمن الذي نُجبر فيه على الوقوف لنعطي الحق لغيرنا في المرور عبر التقاطع، لكن هذه الدقيقة قد تُلخِّص لك حياة المواطن البائس في بلداننا القابعة في أول الزمن وآخر المصاف.
دست على البنزين لأغتنم آخر ثلاث ثوان للإشارة الخضراء، لكنني لم أفلح، بينما لم يستسلم غيري، فأفلت بعضهم رغم احمرار الإشارة، لكن الأمر أخيراً استتب للسيمافرو.
عن يميني رجل سبعيني يمضغ فمه المهجور، التفت إليَّ بكامل رأسه وحدجني بنظرة عميقة وهو يعصر عينيه ليتبيَّن ملامحي جيداً، أعرف أنه لا يبحث عن شخص يُشبهني ضاع منه، ولا يُفتش عن شيء أفلت من ذاكرته يريد استذكاره من خلال التدقيق والتدقيع في ملامحي، لكنها عادة الليبيين عندما توقفهم دقيقة السيمافرو، أول ما يستفتحون به دقيقتهم هي إمالة رؤوسهم يميناً وشمالاً وكأنهم يختمون صلاة بلا قِبلة.
وجهه العابس المتجهم وكأنه يتهمني بأنني السبب في نقص السيولة وتأخر مرتباته المتكرر، أو كأنني أنا المسؤول عن سلاطة لسان عجوزه، وتسلطها عليه، وخروجه من البيت بلا إفطار، أو أنني المسؤول عن السبعين خريفاً التي قضاها في بلدٍ عربي.
برم رأسه فجأة إلى الناحية الثانية، أحسست وكأنه يقول لي: “تباً لك ما أقبحك!”
وبرمتُ رأسي أنا أيضاً إلى الناحية الثانية..
امرأة أربعينية.. يبدو واضحاً أنها ليست على وفاق مع الجمال، كانت تعبث بنقالها لتصطبر على طول الانتظار الذي يمتد لستين ثانية.
تأملت الأصباغ التي تُغطي رقعة وجهها، كانت أشبه بلوحةٍ تشكيلية لرسام لا علاقة له بالفن التشكيلي. أحسست لوهلة بأنني على قدر لا بأس به من الجمال والوسامة، وأنني أستطيع خوض مسابقة لأجمل كائن حي، شريطة أن يكون كل المشتركين على قدر جمالها.
انتبهتْ لوجود عينيَّ على وجهها..بادرتها بابتسامة بريئة، كاعتذار عن بلادة نظراتي، فأغلقتْ زجاج النافذة الملون في وجهي.
أدرت رأسي ناحية السيمافرو وأنا أشعر بشيء من الهزيمة في صراع لم أخضه، وبشيء من الخيبة التي لم يسبقها أي نوع من الأمل، وبشيء من الفشل في شيء لم أحاول فيه، وبردٍّ قاسٍ على شيء لم أطلبه !
السيمافرو يعد ثوانيه الأخيرة.. كنتُ في المقدمة.
المقدمة الوحيدة التي لا يحسدك عليها أحد، الجميع خلفي يطلقون أبواق سياراتهم وكأنهم يريدون مني أن أتجاوز الثواني السبع الأخيرة، شعرتُ بأن تجاوزها أشبه بإفطار صائمٍ قبل أذان المغرب بسبع ثوان.
انطلق الجميع وكأنهم سمعوا إشارة الانطلاق في خط سباق، كانوا متوترين جداً، ومسرعين جداً، ومستعجلين جداً وكأنهم يُسعفون مريضاً على وشك الموت، وكنتُ مسرعاً بسبب مزاميرهم التي تحُوشُني أمامهم، وكأنني مجرمٌ تطارده سيارات الشرطة.
لكن الذي يُطارني فعلاً ليسوا هم، ولا رجال الشرطة، بل تلك الأسئلة اللعينة التي وُلدت في تلك الدقيقة:
إلى أين يذهبون؟ وماذا يصنعون؟ ولماذا هم مستعجلون إلى هذا الحد؟
وغيرها من الأسئلة الكثيرة المقلقة كالقلق الذي ينتابك حين يُطلب منك الانتظار لستين ثانية !
وستكون الإجابة عليها مؤلمة إذا ما قورنت بحجم الإنجاز!
وستكون محاولة إثارتها مفجعة كالفجيعة التي ستبوء بها إذا ما حاولت كشط وجه تلك المرأة التي أغلقت (الروشن) في وجهي.