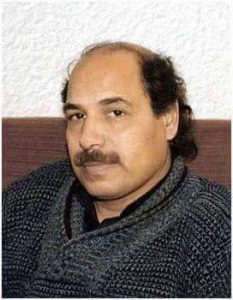عبير خالد يحيي
“ياحظي من الطلب القادم”
سمحت لنفسي أن تراهن على حظها من (التوصيلة) القادمة بعد عدّة مشاوير خائبة، أو على الأقل، كما يقول المثل البلدي: (مش جايبة همّها)، ويبدو أن الدولاب دار، والسماء ستمطر، هذا ما استنبأته من الإشارة الصوتية التي انطلقت من جوّالي.
هو عملي الإضافي الذي تعشّمت فيه رزقًا جيدًا يسند الحصوة التي أتحصُل عليها من عملي الوظيفي، وأتاحته لنا شركات النقل الخاصة التي تؤمن خدمة التوصيل عبر التطبيقات الالكترونية، حظيتْ سيارتي بالقبول لدى شركة (أوبر) العالمية، وبدأت العمل كسائق في الفترة المسائية، كان يومًا صيفيًّا بامتياز، أسقطه شهر يوليو من التقويم، كنت أقود سيارتي في شارع (أبو قير) مقتربًا من (فكهاني النصر)، وكانت الساعة حوالي الواحدة ليلًا، والطلب الوارد إلى (موبايلي) مشوار يبدأ من منطقة (كفر عبده)، وينتهي عند شارع (العيسوي) منطقة (ميامي)، من أمام عمارة فاخرة مواجهة لحديقة (اللمبي) صعدت امرأة أربعينية، مظهرها الأنيق، ملبسها، مكياجها، وعطرها، يعكس حال طبقتها الاجتماعية الثرية التي يمتاز بها معظم سكان هذه المنطقة، لكن الغرابة التي سرقت انتباهي هي نصفَي بطيخة، بيضاء تمامًا، تحملهما بارتباك بكلتا يدَيها، بنبرة عصبية، طلبت مني أن أفتح لها باب السيارة، ناولتني نصفَي البطيخة (القرعة)، واستقرت على المقعد الخلفي، ثم تناولتهما مني، ووضعتهما بجانبها على المقعد. بقيتْ صامتة لم تتكلّم طوال الطريق الذي يستغرق حوالي ثلاثة أرباع الساعة وقد تزيد، فقط زفرات تنمّ عن انزعاج وغضب، وكأنها تدير في داخلها معركة غير محسومة، لكنها تتوعد بحسمها قريبًا.
يحمل الصيف للإسكندرية حمولة زائدة من البشر، تغصّ بها الشوارع و(الكافيهات) التي تغوّلت وأكلت كورنيشها الشهير، ولم تترك على الشاطئ مكانًا لغزّة دبوس، حتى أن الأهالي أخذوا يتندرون مقترحين اسمًا جديدًا لها،( الاسكندرية كافيه)!. وأمام هذا الزحف البشري الهائل الذي يطلقون عليه اسم ( المصطافين)، كان أمر التأخير، بسبب العرقلة المرورية، واردًا بدون أدنئ شك، كما كان أمر ارتفاع الأجرة هو الواقع السعيد بالنسبة لي.
وصلنا إلى الموقع الذي حدّدتْه على التطبيق، طلبت مني أن أنتظرها ريثما تنهي مهمة لم تفصح عنها، ولكني أجبتها:
“يجب أن أنهي هذه الرحلة بقيمتها النقدية، وقد تجاوزت المئة جنيه، بعدها يمكنك أن تطلبي رحلة أخرى، أتلقى الطلب وأكون في خدمة حضرتك”.
وفعلًا، حدث ذلك.
المكان الذي وصلنا إليه كان عبارة عن شارع صغير متفرع من شارع العيسوي في ميامي، نزلت السيدة وهي تحمل نصفي البطيخة، واتجهت إلى بسطة البطيخ التي نصبها صاحبها عند الناصية، وقام بتغطيتها بقطع من جوالات الخيش، وضعتْ المرأة نصفي البطيخة أعلى النصبة، ثم تناولت بطيخة ورمتها على الأرض بكل قوة، فانفجرت متشظية بقطع فاض ماؤها أحمرًا على مذبح الرصيف، وسط دهشتي الشديدة وانشداه شابين كانا بالجوار، لم تمنعها صرخاتهما المستنكرة من تناول بطيخة ثانية، وإراقة دمها هذه المرة على قارعة الطريق، وعند الثالثة اكتفت، وكأنها أنهت ذبح أضاحي العيد، مسحت يديها بمنديل، رمته فوق غطاء الخيش الذي أعادت تسويته، وتأكدت من ثبات نصفي بطيختها (البيضاء القرعة) فوق النصبة، وقفلت راجعة إلى السيارة، سألتني:
“كم ستكون كلفة توصيلة العودة؟”
أجبتها:
“تزيد قليلًا عن الرحلة السابقة، أي أكثر من مئة جنيه بقليل، هزّت رأسها، وتمتمتْ بحسبة بسيطة:
“البطيخة ب 100 جنيه تقريبًا، وأنا كسرت ثلاث بطيخات، يعني 300جنيه، دفعت ثمن البطيخة القرعة 100جنيه، والتوصيلة الأولى 100جنيه، وسأدفع 100جنيه ثالثة لتوصيلة الرجعة، يعني حوالي 300جنيه كمان، كدا نبقى خالصين! لا لينا ولا علينا!”.
وأمام نظراتي التي حملت الكثير من الشك والارتياب بسلامة عقلها، بادرتْ بالحكي والتبرير، بنبرة حاولت جعلها هادئة:
” كنت اليوم في زيارة لإحدى قريباتي هنا، خرحت من بيتها حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا، وكان بائع البطيخ واقفًا عند الناصية ينادي على بضاعته: “أحمر يا بطيخ”، ولا أدري كيف استجبت لإغراء الفكرة التي تلوّت أمام مخيلتي، أن أشتري بطيخة، وهذا عمل لم أقم به من قبل في حياتي، أن أشتري بنفسي فاكهة أو خضار، أكتفي بطلبها من السوبر ماركت، أو من فكهاني النصر، لكن، وأمام إلحاح الرغبة الوليدة قرّرت شراء البطيخة من هذه البسطة، وأشرت إلى واحدة بعينها، طلبت من البائع وزنها لأشتريها، ولكن البائع أصرّ أن يعطيني واحدة بعينه هو، ويحلف أغلظ الإيمان أنها “حمراء وطعمها حلو زي العسل، ولو فتحتيها وكانت غير كدا رجّعيها وخدي غيرها”، وأنه سهران هنا للفجر، وصلت البيت وفتحتها، وهالني بياضها اللفتي الناصع وطعمها المز، أخذني الغضب وقرّرت المضي إليه وكأنني في مغامرة استحوزت على كل اهتمامي، مدفوعة بشعور الغبن، وفعلت ما رأيتَ منّي حينما وصلتُ ولم أجده، البائع الغشاش الكذّاب الذي صوّر له خياله المريض أنه ضحك عليّ واستغلّني، مع كل بطيخة رميتها على الأرض كنت أقتل على محيّاه ضحكة، وأغرس في قلبه حسرة، وأخطّ على دفتر عمره درسًا، وعقدتُ محكمتي، حكمتُ ورفعتُ الجلسة، ونفّذت الحكم، فهل أنا مخطئة؟!”.